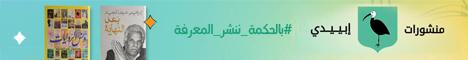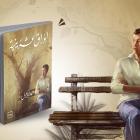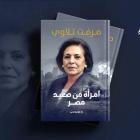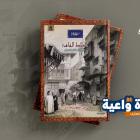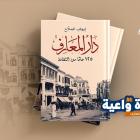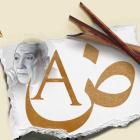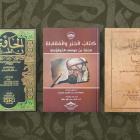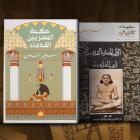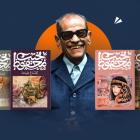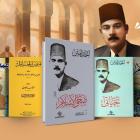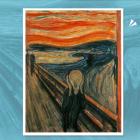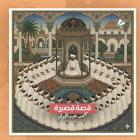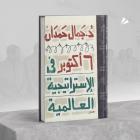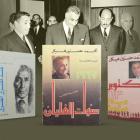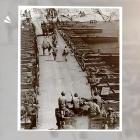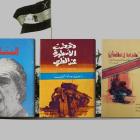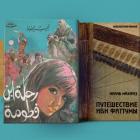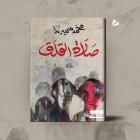في المرة التالية التي يرتطم رأسك بالحائط تذكر أن هناك احتمالًا ألا تنزف أنفك، وينجرح رأسك، وإنما يعبر للجهة الأخرى من الحائط، صحيح أنه ربما يتعين عليك المحاولة لمدة تفوق عمر الكون نفسه ليحدث هذا، لكن صدقني: إذا لم تمت جراء الضربات فالأمر يستحق المحاولة. كانت معكم ظاهرة «النفق الكمي» من ميدان نوبل لعام 2025.
حصد كل من البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل ديفوريه، والأمريكي جون مارتينيز، وثلاثتهم من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025، تقديرًا لاكتشافهم ظاهرة النفق الكمي الماكروسكوبي، وإثبات تكميم الطاقة في الدوائر الكهربية، فما معنى ما اكتشفوه؟ وكيف يمثل الحلقة المفقودة بين عالمنا الكبير وعالم الكوانتوم؟
الذرة.. مدينة بلا سكان
تعرف وحدة البناء المكونة لأي شيء، والعنصر التكويني الأصغر على الإطلاق، باسم الذرة. تتكون الذرة من نواة مركزية تحتوي بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة، يدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة.
لعلنا درسنا كل هذا مسبقًا في مادة العلوم، لكن هناك بعض الحقائق الطريفة حول الموضوع. يفوق حجم الذرة حجم نواتها بما تحتويه من بروتونات ونيوترونات بنحو مئة ألف ضعف.
بتشبيه آخر: تخيل مدرج كرة قدم يحوي 100 ألف مقعد، وفي المقعد الذي يقع في المنتصف تمامًا يجلس شخص وحيد هناك. يمثل المدرج الذرة، والمقعد المشغول يمثل النواة، بينما تترامى الإلكترونات على أطراف المدرج دون معرفة معينة بموقعها. إذا كان معظم الذرة فراغًا فلم لا يمكننا المرور إذن عبر الحائط؟ ولم تظهر المواد بشكلها الصلب المعتاد؟
يمكن شرح الأمر بالتفسير الكلاسيكي المعتاد؛ تتجاذب الشحنة الموجبة للبروتونات مع نظيرتها السالبة للإلكترونات، ما يساهم في إبقاء الذرة كتلة واحدة نتيجة للطاقة الكهروستاتيكية الكامنة بينها.
وبذكر الكلاسيكية، بمقدورنا تقسيم الفيزياء إلى فرعين: الفيزياء الكلاسيكية التي اكتشفها نيوتن وطورها من بعده آخرون، والفيزياء الحديثة التي برزت في مطلع القرن الفائت، وقسمت بدورها إلى عدة فروع منها فيزياء النسبية لأينشتاين، حيث تحكم القوانين الأجرام العملاقة؛ فالجاذبية والحركة وكل مبادئ وقوانين الفيزياء الكلاسيكية في الكون الفسيح تختلف حين تطبق على الأجرام السماوية.
وقد جاء أشهر أمثلة أينشتاين بمثال التوأمين اللذين يسافر أحدهما إلى الفضاء بسرعة تقترب من سرعة الضوء، بينما يبقى الآخر على سطح الأرض، ولدى عودة الأخ المسافر يجد أن توأمه الأرضي قد كبر سنا، بينما هو لا يزال في ريعان شبابه؛ وسبب هذا اختلاف امتداد الزمن لدى السرعات المختلفة، وهو ليس موضوعنا على الإطلاق، إنما هو فقط لإثبات أن هذا المثال على غرابته الشديدة لا يُقارَن بغرابة ميكانيكا الكم. فما هي أغرب مبادئها؟
- يمكن للجزيء أن يتواجد في أكثر من مكان في وقت واحد (التراكب الكمي).
- يمكن أن يؤثر جزيء ما موجود في مجرة على قرار جزيء آخر في مجرة أخرى لمجرد أنهما مترابطان كميًا (التشابك الكمي والتأثير الشبحي عن بعد).
- قيامك بمراقبة نظامٍ كمي يمكن أن يؤثر في سلوك النظام، كما لو كان بشريًا يشعر أنه يراقب (تأثير المراقب).
- في كل لحظة تتخذ فيها قرارًا في حياتك، ينتج عنك مئات من النسخ الأخرى، اتخذ كل منها قرارًا مغايرًا (الأكوان الموازية).
- يمكن للجزيئات منخفضة الطاقة العبور من خلال حواجز الطاقة الكبيرة، رغم أن الفيزياء الكلاسيكية تذكر أنه يستحيل لها التغلب عليها، ناهيك عن العبور خلالها (النفق الكمومي).
النفق الكمومي، وتيار الموصلات الفائقة
لنقارن بين عالمنا العادي والعالم الكمي إذن. إذا ألقيت كرة باتجاه الجدار في عالمنا فإنها بنسبة 100% سترتد إليك. إنها كرة بكل بساطة، ليست رصاصة تفوق طاقتها طاقة الجدار حتى تتمكن من اختراقه! لا يحدث هذا الأمر دومًا في عالم الكم. فإذا ألقيت ذرة ضعيفة في مقابل حاجز طاقة، فهناك احتمال أن ترتد الذرة إليك، واحتمال آخر أن تعبر الذرة الحاجز إلى الجهة الأخرى.
في العالم الكمي لا يوجد شيء اسمه سجن. وإذا اعتقدت أنك يمكنك سجن ذرات بين حواجز للطاقة وتتوقع أن تبقى مكانها إلى الأبد، فأنت مخطئ.. مخطئ جدًا. يعرف هذا المبدأ في ميكانيكا الكم باسم «النفق الكمي/الكمومي»، وينص على أن الجزيء يمكنه عبور حاجز الطاقة حتى إذا لم يمتلك الطاقة الميكانيكية الكافية للتغلب عليه.
في عامي 1984 و1985 أراد علماؤنا الحاصلون على جائزة نوبل للفيزياء لهذا العام 2025، جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيز، إجراء تجربة لتبين الحد الفاصل بين تطبيق قوانين الكم وقوانين الفيزياء الكلاسيكية؛ بمعنى آخر: ما الشروط والحجم الذي ينبغي على رأسك امتلاكه كي تتمكن في المرة القادمة التي تصطدم فيها بالحائط من المرور إلى الجهة المقابلة؟ وإذا أمكن لذرة واحدة محبوسة داخل حاجزٍ عالٍ من الطاقة المرور رغم ذلك، فهل يمكننا تطبيق الأمر على مجموعة من الذرات؟ هذا ما أراد علماؤنا استكشافه.
في الموصلات العادية تتزاحم الإلكترونات مع بعضها البعض داخل مادة الموصل. بنى علماؤنا دائرة كهربية باستخدام موصلين فائقي التوصيل، ثم فصل العلماء بين المادتين فائقتي التوصيل بطبقة رقيقة من مادة عازلة. إذا لم تكن ممن أحبوا الفيزياء الكهربية في دراستك، لنستوضح الأمر سويًّا.
يسري التيار الكهربي في الدوائر الكهربية العادية، تعوقه أحيانًا «المقاومة»، وقد تكون المقاومة عنصرًا مخصصًا في الدائرة الكهربية، أو قد تكون مادة الموصل نفسها. يهدر جزء من الطاقة الكهربية في صورة حرارة. هناك طريقة للتخلص من المقاومة الموجودة في مادة الأسلاك عبر تبريد الموصل لدرجة الصفر المطلق؛ وفي هذه الحالة تعرف المادة بأنها فائقة التوصيل. ولا يتولّد فرق جهد لنقل الطاقة من النظام؛ بمعنى آخر: لقد بنى العلماء سجنًا صغيرًا للتيار الكهربي المتولد.
في المواد الموصلة العادية، ينتقل التيار الكهربي بسبب وجود الإلكترونات الحرة التي تتحرك عبر المادة بأكملها، وفي حالة التبريد إلى الصفر المطلق تنهار المقاومة التي تلاقيها الإلكترونات، ما يسمح لها أن تنساب مكونةً رقصةً إيقاعية تتدفق بلا توقف. في هذه الحالة تعرف المادة بأنها فائقة التوصيل، بينما تقترن الإلكترونات وتترتب في أزواج تعرف باسم «أزواج كوبر».
تتصرف أزواج كوبر باختلاف شديد عن الإلكترونات العادية؛ فبدلًا من التنافر الحادث بين الإلكترونات الحرة، والذي يبقيها على مسافة من بعضها ويجعل كلًّا منها مميزًا عن أخيه، يحدث العكس في أزواج كوبر؛ إذ يمكن وصف إلكتروني كوبر بأنهما وحدةٌ واحدة، ومع العديد من أزواج كوبر نكون قد أسسنا نظامًا كميًا واحدًا. في المواد فائقة التوصيل تتحد الإلكترونات في صورة «أزواج كوبر».
الأنفاق الكمية في العالم البشري
كما في القوانين البشرية، فالأحكام التي تسري على الأطفال لا تسري على الكبار؛ في الفيزياء يحدث الشيء ذاته. الأحجام الصغيرة —الكمية— تحكمها قوانين لا تحكم الأحجام الكبيرة. لنقرب الأمر بمثال جريمة القتل: إذا ارتكب رجلٌ بالغ جريمة قتلٍ يتلقى عقابًا شديدًا قد يصل إلى الإعدام، بينما لو نفذ الشيء ذاته طفل غير بالغٍ بعد يتعرض للتأهيل النفسي فقط.
إن السن الفاصل في القانون في بلادنا ثمانية عشر عامًا؛ بمعنى إن عقوبة ارتكابك جرمًا ما قبل عيد ميلادك الثامن عشر بيوم مختلفة كل الاختلاف عن عقوبة ارتكاب الجرم نفسه بعد عيد ميلادك بيوم واحد. الأمر نفسه في الفيزياء: القوانين التي تحكم الأنظمة الصغيرة —الكمية— مختلفة تمامًا عن قوانين الأجسام الأكبر، لكننا لم نكن نعلم عن الحد القانوني الفاصل بين قوانين النظامين حتى جاء علماء نوبل 2025 واقتربوا من اكتشاف الأمر.
تسلك «أجزاء كوبر» كما لو كانت جزيئًا واحدًا. لقد بنى علماؤنا جون كلارك وميشيل ديفوريه وجون مارتينيز تجربةً حولوا فيها مجموعةً من الإلكترونات —يسلك الواحد منها سلوك المادة دون الذرية— إلى وحدةٍ كميةٍ واحدة تسلك كلها السلوك نفسه، لكنها أصبحت مرئية الآن وقابلة للرصد والتفسير. رغم إطلاقنا عليه «العالم الميكروسكوبي»، فإن العالم الكمي قد يضم عناصر نعجز حتى عن مراقبتها باستخدام الميكروسكوب؛ لهذا لزم الاحتفاظ بنفس القوانين التي تحكم هذا العالم، لكن مع زيادةٍ في الحجم القابل للرصد.
لنعد إلى مثال الأطفال: إن طفلًا صغيرًا يقوم بسرقة قطع الشوكولاتة من مصنعٍ كبير قد لا تلحظه عدسات المراقبة، لكن إن اتحدت مجموعةٌ من الأطفال سويًّا وفعلت الشيء ذاته نكون قد نلنا كلا الحسنيين: وجود الأطفال تحت السن القانوني سيساعدنا في تطبيق قوانين الكمية، وتجمهرهم سويًّا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على الإفلات من سجلات المراقبة؛ أي رؤية التجربة بالعين المجردة. ولا نقصد هنا الأطفال، بل الإلكترونات، وبالطبع لم نقصد أيضًا مصنع الشوكولاتة!
لقد صمم علماؤنا تجربةً لمرور التيار الكهربي، تأكدوا فيها أن الإلكترون —«الطفل سارق الشوكولاتة»— هو بطل القصة، وحرصوا على تواجد المزيد من الأطفال. إن تواجد العديد من الإلكترونات في تلك الدائرة الكهربية، في ظروف معينة —المواد فائقة التوصيل— جعل منها تتصرف كما لو كانت نظامًا كميًا كبيرًا بما يكفي لنقوم برصده. فوقوف طفلين فوق أحدهما الآخر ليصلا إلى رف الحلوى العلوي لن يجعل منهما شخصًا كبيرًا، كذلك إلكترونات كوبر. ومن ثم لم يتبق سوى اختبار النتائج وتأكيد حدوث ظاهرة النفق الكمي في التجربة، وهو ما لم يكن صعبًا على الإطلاق.
تنص ظاهرة النفق الكمي على أن الإلكترون يمكنه الهروب من حاجز طاقة حتى لو كان الحاجز يفوق طاقته. لقد بنى العلماء سجنًا للتيار الكهربي، وحرصوا على انعدام المقاومة ليتأكدوا ألا يفقد النظام أي طاقةٍ في شكل فرق جهدٍ؛ لذا فإن أي فرق جهدٍ متولدٍ يعني وجود اختراقٍ لحواجز طاقة النظام الكمي المقام، وهو ما سجله العلماء بالفعل؛ لقد اخترقت الكرة الجدار!
تفسر ظاهرة النفق الكمي بمرور الإلكترونات بالدالة الموجية، وهي معادلة في ميكانيكا الكمّ تذكر أن الإلكترون لا يتواجد في مكانٍ واحد، وإنما يتواجد في هيئة سحابة يمكن أن يتواجد في أي نقطةٍ فيها. فكّر في الأمر على أنه سحابةٌ عاديةٌ من بخار الماء تتركز المياه في نقطةٍ ما فيها ونحن لا نعلم أين هي تلك النقطة.
تتحدد مواقع الإلكترونات في سحبٍ مترامية على أطراف الذرة؛ صحيحٌ أن طاقة أيّ إلكترون قد تكون أقل من حاجز الطاقة الذي يغلف الذرة، لكن مجرد تواجد أجزاء من السحابة خلف هذا الحاجز يعني أن هناك احتماليةً أن يتواجد الإلكترون نفسه بالخارج، متحررًا من حاجز الطاقة الذي لم يكن يقوى على مواجهته منفردًا بقوانين الفيزياء الكلاسيكية.
ما بعد نوبل
لتجارب علمائنا العديد من النتائج التي تساهم في فهم ميكانيكا الكم. إن فكرة استخدام جزيئات ميكروسكوبية دون ذرية، بخصائصها الكمية، لتكوين نظام ماكروسكوبي ذي خصائص كمية قابل للرصد بالعين المجردة هي معجزةٌ في حد ذاتها. تمكن العلماء بتطبيق هذا المبدأ من تطوير تطبيقات مثل الليزر، والموصلات الفائقة، والسوائل فائقة الميوعة.
لكن يظل الإنجاز الأكبر لم يكتشف بعد؛ تطبيق هذا المبدأ قد يمكننا من تنفيذ كل التجارب النظرية؛ تجربة مثل «قطة شرودنجر» قد نتمكن من تجريبها عمليًا يومًا ما. مبادئ ميكانيكا الكم كلها قد نتمكن من تطبيقها على المستوى البشري: أن يتواجد الإنسان في أكثر من مكان في الوقت نفسه، أن تؤثر حالة إنسان على حالة إنسان آخر مترابط معه كميًا في مكانٍ ما في الكون السحيق، أو ربما لو رتبت إلكترونات دماغك في شكل أزواج كوبر لن تتنافر مع إلكترونات الحائط، ووقتها فقط ربما يمكن لرأسك أن يعبر للجهة الأخرى من الحائط، ووقتها فقط يمكن أن تشعر بمدى هول ما حقّقه العلماء.